اللامبالاة . حياة بلا أمل . عذاب سيزيف
الإنسان اللامبالي:
هو نتيجة حتمية لصراعة مع الحياة من أجل أن يجعل لذاته مكانه وبطبيعة الحال هذه المكانة هي من ستجعل لحياته معنى يستطيع من خلالها الإحساس بالوجود وانه ذا قيمه في أصل الوجود.
لكن حينما لا يجد ما يستطيع من خلاله أثبات ذاته وأنه أنسان يستحق الحياة وأنه من الممكن أن يكون صاحب قيمة مضافة لحياة البشر, يبدأ بفقدان شغفة بالتدريج الى أن يفقد قدرته على التفاعل مع الحياة, وهذا الإحساس الذي يبدأ بالتشكل داخله سيبدأ تأثيره بالتدريج الى أن يعزله عن محيطة ومن ثم عن البشر ومن ثم ينسيه قيمته الإنسانية من خلال فقدانه الأمل بطبيعة وجودة, وعندما يفقد الأمل يفقد أي دافع على الاستمرار بصناعة الأهداف أو الهدف الذي من خلال السعي لتحقيقه يجد أنه ذا قيمه ولحياته معنى .
لكن بفقدانه كل هذه الدوافع يبدأ بصناعة عالمة الخاص, ذلك العالم اللامتزن واللامستقر والمبهم المعالم, كل هذا سيكون في خياله وذاكرته التي ستزدحم بسلبيات الحياة وطبيعة الوجود وغايات وجوده هو, فيتحول الى ذلك الإنسان الوحيد الذي يرقب حياة الناس دون الاحتكاك بهم, ويبني استنتاجات لا علاقة لها بواقع حياة البشر الا في بعض الأجزاء , مثل البطالة , قلة فرص العمل وكثرة المتنافسون عليها , الفقر , الجوع , شتات البشر لأسباب غير منطقية , كل هذه الأمور والأحداث تصنع أنسان لا مبالي فاقد الإحساس بالحياة والناس, لأنه يسمع صوت صراخ المتنافسون على الحياة لكن بلا صوت, ويسمع صراخ الفقراء والجوعى بلا صوت, يسمعهم ويستشعر آلامهم لأنه يسعى جاهدا لأن تكون هذه طبيعة حياة البشر, ليبرر لنفسة أو ليجد لنفسه الضائعة وسط هذا الزحام ملاذ يختبئ فيه, واذا تحدث إليهم تحدث بلغة لا تمت للمنطق ولا للمعقول بأي صله, كلماته من قعر الإحباط يلتقطها ليدسها في أسماع المحبطين والفاقدين للقيم الذاتية , يسمعهم ما يدفع بهم الى الالتحاق به الى عالم اللامبالاة , حيث عالم البهيمة والغرائز النفسية, عالم فصل العقل عن الجسد وإيقافه قسرا عن التفكير.
لأن اللامبالي لا يريد أن يعلم أصل طبيعة خلقه والغاية والهدف الأسمى لوجوده , ويسعى لجعل حياته بهيميه, وهذا النوع هو الشق الغرائزي في حياة الحيوان القائم على الجنس والتكاثر, لكن هو لا يبحث عن الجنس فقط, بل الجنس وكل ما يساعده على فقدان قدرته على التفكير, فيسلك طريق المسكرات والمخدرات.
واذا اقتربت منه لتسأله لماذا؟ سيجيبك أنه لا شيء يستحق في هذه الحياة , وفي علم النفس نسمي هذه المرحلة الذهاب بلا عودة, أي أن الإنسان الذي يصل الى هذه الحالة من الضياع الفكري والنفسي يصبح من المستحيل أعادته الى واقع الحياة الطبيعية. ولدينا أمثله كثيرة في وقتنا الحاضر, حيث تنتشر المخدرات والجريمة والجنس بلا ثمن , غالبا ما ينتهي بهم الحال الى الموت أو الانتحار.
_سأذكر قصة سيزيف ذاك المعذب برفع الصخرة الى رأس الجبل ومن ثم تسقط ليعيد رفعها مرة أخر الى ما لا نهاية , سيزيف الذي حكمت علية الآلة اليونانية بهذا الحكم الأبدي.
ولماذا حكم علية بهذا الحكم الذي ستفنى حياته وهو يحاول أنفاذة دون أن يصل الى نتيجة, لكنه أستمر بهذا الفعل الى ما لا نهاية. لأنه أخطئ والإنسان الحر في مفهوم الآلة اليونانية القديمة هو الذي يخطئ, أما العبد هو من لا يخطئ لأنه لا يختار ما يفعل , وإنما أختار له سيدة ما يفعل . وأعجبني أسقاط الكاتب أنيس منصور لحياة المعذب سيزيف على واقع حياتنا الحالي , بسرد خيالي جميل وكأنه يحكي حياتنا اليوم , فقال .
الإنسان الحر هو الذي لا يعرف حدودا لحريته, وهو الذي يصطدم بالقيود التي وضعها غيره من الأحرار, أو غيره من الآلهة, لأن الآلهة عند اليونانيون القدماء. ينافسون البشر في قيودهم وفي حرياتهم المحدودة كانوا يشربون وكانوا يرقصون وكانوا يخطفون النساء وكانوا على خلاف مع البشر. لكن الأحرار من بني الإنسان لم يجعلوا رؤوسهم أحجارا صغيرة في طريق الآلهة وإنما رفعوا رؤوسهم الى حيث ارتفعت رؤوس الآلهة.
وكانت تلك خطاياهم, فاستحقوا لعنة الآلهة وعذابهم وقد أعد الآلهة جهنم للأحرار, أما العبيد فلا يراهم الآلهة, لذلك يدخلونهم الجنة مع البنات والحيوان والأنهار والجبال, وأنا أستطيع أن أسألك : قل لي من الذي يلعنك؟ اذا كان إنسان , فأنت إنسان ,أما إذا كان إلها, فأنت بطل.
وهذا هو البطل سيزيف ,إنه أسمى من العذاب وأقوى من حكم الآلهة فهو يعلم أولا, أنه محكوم عليه, وهو يعلم أن هذا الحكم لا رجعة فيه, وأن هذا العذاب مدى حياته أو مدى حياة الآلهة , ولكنه مع ذلك يرفع الحجر ويلاحقه إذا نزل , وينحني عليه ويحرص ألا يسقط من يديه وهو يرفعه , أنه يؤدي هذا العذاب كما لو كان واجبا مقدسا .
إن صلاته اليومية أن ينحني على الحجر , ويرفع رأسه إذا سقط, أنه يقاوم المستحيل, ويعلم أنه يقاوم المستحيل, ومع ذلك يستمر في مواجهة المستحيل .
وهل سيزف وحده الذي يدفع الأحجار أمامه , وتسقط منه الأحجار. أبدا, بل كلنا ذلك الرجل , بل كلنا أكثر تعاسة وشقاء منه هذه هي حياتنا, إننا محكوم علينا بأن نعيش , فقد نزلنا أو أنزلنا على هذه الأرض , ولا نعلم شيئا عن حكمة حياتنا أو عن غاياتنا , لا نعلم شيئا وكل الذي نعلمه, أننا نعيش ونواصل العيشة هكذا دائما .
ولكن أليس لهذه الحياة طعم أو لون أو حتى لذة مؤقتة,؟ هذه الحياة بلا معنى ولا طعم. ولكننا نجد للحياة طعما ومعنى وسبب ذلك يرجع إلى الدين والفن والحب .
فإذا لم يكن دين لم يكن أمل, وإذا لم يكن فن لم يكن معنى وإذا لم يكن حب لم تكن علاقة , ولا حياة بلا أمل ولا معنى ولا علاقة.
إنه الأمل , وما هو الأمل ؟ إنه اليأس , وكيف يكون ذلك إن الذي يأمل في شيء معناه أنه يائس من شيء, ويرى أن هنالك شيئا آخر أحسن وأفضل من هذا الذي لا يعجبه , ولذلك فهو يأمل في شيء. فالأمل واليأس شيء واحد . والفن هو الآخر كذلك , والحب تستوي فيه الكرامة والتضحية فماذا نصنع إذن في حياتنا هذه؟
هل نترك الدين , ونهجر الفن ونقاطع الحب, ولماذا لأن الحياة بلا معنى ولا هدف ولا غاية ولا أمل فيها ولا يأس. فالعالم لا معنى لبدايته ولا معنى لنهايته , ولا حكمة لغايته , فكيف نعيش إذن , هل نركن لرجال الدين ونضع قلوبنا في أيديهم ونسير وراءهم عبر المخاوف واليأس والدموع , إلى ذلك اليوم الموعود.
هل نسير وراء الفلاسفة , وهم أكثرنا حكمة وأبعدنا نظرة وأكثرنا إخلاصا في البحث عن الحقيقة وراء حياتنا. أبدا لا يجب أن نسير , ولا نعرف إلا أن نرفع الحجر وإلا أن ننزل وراءه إذا سقط . إننا محكوم علينا بالحياة. ثم من هم الفلاسفة الذين تريد أن تسير وراءهم.
أهو ذلك الذي يعد بجنة العمال , بجنة الأيدي بلا رؤوس , بجنة المعدات بلا عقول , بجنة عرضها المصانع والحقول , بجنة فاكهتها المحرمة هي الحرية , أهو كارل ماركس , أهو ذلك الآخر الذي يقول إنك ورقة توت في شجرة توت وليس لك معنى ولا وزن, إلا إذا كنت ورقة في هذه الشجرة فإذا سقطت من هذه الشجرة فلست ورقة على الإطلاق , فالحياة للشجرة والموت للورقة , أهو الذي يقول لك أن الفرد لا قيمة له إلا لأنه فرد في الدولة , فالحياة للدولة والموت للأفراد ,أهو الفيلسوف هيجل, أم هو الذي يقول لك ,أنه لا إله هنالك , ولو كان هنالك إله لكان هو نفسة ذلك الإله, ثم يجعل منك حذاء في قدمي موسوليني وهتلر, لأن الفرد هو الميكروفون الذي يتحدث فيه الطاغية البطل, أهو الفيلسوف نتشيه.
إن العالم الذي نكتوي بناره وطاعونه هو العالم الذي خلقة حضرات الفلاسفة , هيجل وماركس ونيتشه.
ولم نعرف فنانا واحدا أعلن حربا أو أهلك زرعا أو حرق بيتا أو فتح السجون للأحرار الخاطئين.
لأن الفنان حر , والحرية هي أن يكون لك الحق في أن تخطئ وفي أن تصيب على السواء, والإنسان الحر هو الذي يحب الحرية للآخرين , أنه الذي يخطئ ويعلم أن الآخرين يخطئون كذلك. أما الذي يستمتع بحريته هو ويحرم الآخرين. فهو الطاغية الذي يحرق له البخور حضرات السادة هيجل وماركس ونيتشه. ولكن إذا كانت الحياة بلا معنى أو إذا كانت الحياة سخفا في سخف , فكيف احتملها الإنسان, ما هي مانعات الصواعق التي استخدمها الإنسان حتى لا تصعقه الحياة بسخفها. أما مانعات الصواعق فهي, الدين , والفن , والحب , ولكن كيف استمر الإنسان, حيا يقاوم السقوط إذا سار ويقاوم الموت إذا وقع في خطر, ويقاوم الرتوب والملل, إنها حياته الوحيدة, وليست له حياة غيرها وهو لا يريدها أن تضيع عليه. وقد ارتبط مع الآخرين من بني جنسه ليعيش وليقاوم ولينفذ حكم الحياة فيه. إنه التماسك, تماسك الأفراد أمام الشيء الواحد, أمام الخطر الواحد. ذلك الخطر الواحد, هو الحياة بسخفها وتفاهتها وخلوها من المعنى والدلالة. فعندما اجتاح الطاعون إحدى المدن الإفريقية واجتاح الطاعون السياسي أوربا. وقف الناس صفا واحدا, وقف رجل الدين, ووقف الطبيب ووقف السياسي, أنهم جميعا يقاومون خطرا واحدا. فرجل الدين يراه غضبا من الله, والطبيب يراه مرضا يجب مقاومته, ولا يجدي معه الإيمان بالله أو عدم الإيمان بالله, والسياسي يرى الفئران تحمل الطاعون لنأكل الحياة من الأحياء, إنها تأكل الحرية .
ولكن لماذا يتماسك الناس, إذا كانت الحياة بلا معنى ولا هدف ولا غاية. لأن الإنسان هو الكائن الحي الذي يقيد نفسه بمحض اختياره, ويحرص على قيوده, كمظهر من مظاهر حريته. إن الرجل الياباني الذي يدخل الطوربيد ويجلس في مقدمه وينطلق نحو الهدف, ويعلم أنه سيموت, ويحرص دائما على أن يصيب الهدف ويحس بالندم إذا سقط بعيدا عن الهدف. مع أنه سيموت على أي حال. وأنه إذا مات وهو حريص على مبدئه, فلن يدري به أحد, وإذا مات دون حرص على هذا المبدأ فلا يدري به أحد. ولكنها الإنسانية الحرة التي تعبد القيود وتباركها. إنها التي تدفع الحر بصبر دائم, مع أنه لا جدوى من الصبر ولا جدوى من اليأس.
والوجود والحرية معناها واحد. ففي اللحظة التي يوجد فيها الإنسان يكون حرا كذلك. وهو يمسك حريته في يده كما يمسك المنديل وينشره ويطويه. ولكن الوجود سخف في سخف, إذن الحرية هي الأخرى سخف في سخف. فقل لي كيف كان يتصرف الإمبراطور كاليجولا, لقد كان حرا, بل كان يهب الحرية لرعاياه, ويحرمها رعاياه, لقد كان يدخل الرجل في ملابس المرأة, والمرأة في ملابس الرجل, ويعطي الحياة لمن يشاء, ويبعث إلى الموت من يشاء, وكان يضحك الناس ويبكيهم, لقد كان حرا وكان يمارس حريته, وكانت كل المتناقضات تلتقي في أفعاله لقد كانت الحرية سخفا لا معنى لها.
ولكن كاليجولا لم يكن سعيدا, لأنه يريد المستحيل , كان يريد القمر وأصبحت الحرية عنده, بلا معنى ولا طعم, وأصبحت عند الذين ذاقوا مرارتها, بلا معنى ولا طعم, فلا نهاية لها ولا بداية لها, ولا أحد يتوقعها ولا أحد يفرح بها ولا يخاف منها, فهي تتغير وتتبدل وليس لها لون ثابت ولا طعم ثابت ولا غاية واضحة, إنها سخف في سخف. فالوجود سخف, والحياة سخف, والحرية سخف, إنها أسطورة سيزيف الباقية ما بقي الإنسان أو ما بقيت الأحجار, أو ما بقيت الآلهة.
_ ليعم السلام الأرض وليمت معذب سيزيف _
_ ليتنفس أحرار العالم إنسانيتهم وليكسروا قيود سيزيف _
أسامة حريدين \ Ossama Hreden

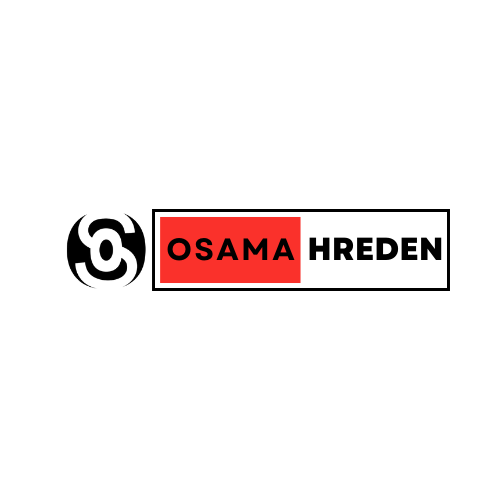
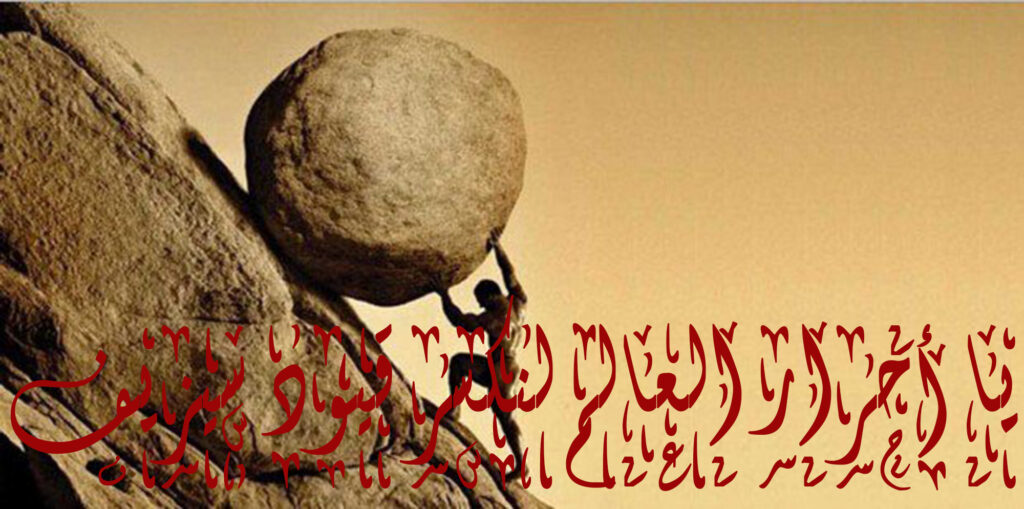
دائما ما تبهرنا بكتاباتك أستاذ أسامه . كل التوفيق .
مقالة تستحق الوقوف والتفكير فيها جيدا
والله مبدع دائما وفي تقدم دائم ان شاء الله
Wonderful insights! The way you break down the complexities is commendable. For additional information on this topic, I recommend visiting: EXPLORE FURTHER. Keen to hear more opinions from the community!
Wonderful insights! The way you break down the complexities is commendable. For additional information on this topic, I recommend visiting: EXPLORE FURTHER. Keen to hear more opinions from the community!
This article was a fantastic blend of information and entertainment. It really got me thinking. Let’s discuss further. Click on my nickname for more thought-provoking content!