أولا أذا أردنا أدراج هذا المفهوم تحت التفسير العقلاني المفهوم لعامة الناس , يجب علينا أن ننزع عنة ثوب الفلسفة المعقدة التي يحتويها هذا المصطلح من خلال ربطه باللغات اللسانية وبنفس الوقت ربطة بين اللغات اللسانية المختلفة مثلا اللسان العربي اللسان الإنكليزي , هذا مثال بسيط يحتاج إلى بعض التركيز ,مثلا نقول في تشابة لفض الكلمات في لغات مختلفة أنها متشابة من حيث طبية الصوت الذي نطقها فهذا يخيل لنا أن اللغة متشابهة ونفس صوت الكلمة لذلك هي تحمل ذات المعنى او القصد ,لكن هذا غير صحيح من الممكن أن تتشابة الكثير من الكلمات بين لغات مختلفة ولهذا نسبية خاصة من حيث التشابة بالمعنى والقصد هنا نحن البشر نقول كلمة نسبيا ـو نسبية أو تماثل وهكذا والقصد هو تقريب وجهات النظر من حيث المعنى الدلالي للكلمة والقصدية وهذا الشيء يسهل على اللغويين وهم المسؤولون عن تطوير اللغة التي تتكلمها الشعوب المختلفة ,لأنهم أن أستطاعو أيجاد نسبية معينة من حيث مخارج الحروف وصوت الكلمة ومستواه وبنفس الوقت يستطيعون بناء قاعدة بيانات نسبية أو متقاربة بين لغتين أو أكثر ,هذا له هدف نبيل جدا وهو تسهيل تعلم أكثر من لغة للإنسان وهذا يسهل علية سبل الحياة في التعامل مع الشعوب المختلفة وبنفس الوقت يجعلة يقترب بسرعة أكبر من فهم التركيبة المجتمعية أو البنيوية لهذا المجتمع .
وهنا سنعود إلى كتابنا ونرى كيف فسر مفهوم النسبية من وجهة نظر كتابنا اللغويين والسيميائيين .
_النسبية : يؤكد سوسور على الطبيعة الإعتباطية للإشارة ,لكن معظم السيميائيين يشددون على إختلاف الإشارات من حيث درجة الإعتباطية | الإصطلاحية ,أو الشفافية في المقابل فيها وتعكس الطبيعة الرمزية النسبية في الإشارة شكلا واحدا من أشكال العلاقة بين الدالات ومدلولاتها وبالتحديد يعود التمييز البديهي بين الإشارات الإصطلاحية الأسماء التي نطلقها على الناس والأشياء والإشارات الطبيعية (صور تشبة ما تصورة ) إلى زمن الإغريق (مؤلف أفلاطون كراتيلوس .
بعد ذلك ميز القديس أغسطين بين الإشارات الطبيعية والإشارات الإصطلاحية من منطلق آخر بالنسبة إلية ,الإشارات الطبيعية هي التي تفسر كإشارات بالإستناد إلى صلة مباشرة مع ما تدل علية ,على الرغم من أنة لم يتم إبتكارها عن قصد (ويعطي مثالا الدخان الذي يدل على وجود نار ,آثار الخطوات التي تدل على مرور حيوان ) في العقيدة المسيحية ,الكتاب الثاني ,الفصل الأول وكل من النموذجيين ,الإشارات الطبيعية (الأيقونية والتأشيرية ) وتلك الإصطلاحية (الرمزية ) موجودة في التصنيف الثلاثي الواسع التأثير الذي صاغة تشارلز بيرس .
لهذا لم يصنف سوسور الإشارات إلى أنماط ,لكن تشارلز بيرس كان مدمنا على الصنافة ,وقدم عدة تصنيفات . وما أعتبرة تقسيم الإشارات الأكثر أساسية قد تمت الإشارة إلية بشكل واسع في دراسات سيميائية لاحقة (وضع تصميمة الأول في العام 1867) وعلى الرغم من أن هذا التصميم غالبا ما يوصف بأنة فرز لمختلف أنماط الإشارات , من المفيد أكثر أعتبارة يبين صيغ العلاقات بين حامل الإشارة ومدلولاتها ,وتقوم هذه العلاقات وفق نموذج بيرس بين الممثل والموجودة أو التأويل المتعلقين به , لكن لكي أستمر في التحليل الذي بدأتة أتابع إستخدام المصطلحين السوسوريين (دال,مدلول ) وفي ما يلي النماذج الثلاثة :
1_رمز \ رمزي: وهي صيغة لا يشبه فيها الدال المدلول ,إنما هو إعتباطي في أساسة أو محض إصطلاحي لذاك يجب إقرار هذه العلاقة وتعلمها ومثال الرمز ,اللغة بشكل عام إضافة إلى اللغات الخاصة وحروف الأبجدية وعلامات الوقف والكلمات وتراكيب الجملة والجمل والأعداد وشيفرة المورس وإشارة السير الضوئية والأعلام الوطنية .
2_أيقونة |أيقوني : هي صيغة يعتبر فيها الدال شبيها بالمدلول أو مقلدا له (يمكن التعرف على شبهه في المنظر أو الصوت أو الإحساس أو المذاق أو الرائحة ) يشبهه في أمتلاكة بعض صفاتة ومثال الأيقونة لوحة لوجه ,والكاريكاتور والمجسم والكلمات المحكية والإستعارات والأصوات الواقعية في برنامج الموسيقى والتأثيرات الصوتية في الدراما الإذاعية وما يسمى المسيقى المرافقة والإيماءات المقلدة .
3_ المؤشر \ تأشيري : وهي صيغة ليس الدال فيها إعتباطيا ولكنه يرتبط مباشرة وبطريقة ما (ماديا أو نسبيا ) بالمدلول ويمكن ملاحظة هذه الصلة أو إستنتاجها ومثال المؤشر (الإشارات الطبيعية ) الدخنة , الرعد , آثار القدم ,الصدى ,الروائح والنكهات غير الصناعية ,والعوارض المرضية (الألم ,الطفح الجلدي ,معدل دقات القلب ) وآلات القياس (دوارة الهواء ,ميزان الحرارة ,الساعة ميزان الكحول ) والعلامات مثلا طرقة الباب , رنة الهاتف ,أدوات التأشير (التأشير بالسبابة ,معلم الإتجاه )والتسجيلات (الصورة الشمسية ,الفيلم ,التصوير بالفيديو أو التلفزيون ,التسجيل الصوتي ,الأثار الشخصية ,مثلا الخط ,التعابير الشخصية .
هذه الصيغ الثلاث تنبع من النموذج الثلاثي للإشارة عند بيرس ,وهو مصدرها فمن المنظور البيرسي من الإختزال تحويل العلاقة الثلاثية إلى علاقة ثنائية ولكن ما نريد التركيز عليه هنا هو كيفية تبني كتابات بيرس وأقلمتها في التقليد البنيوي الأوروبي ولعل إنتشار إستخدام التمييزات البيرسية المذكورة في نصوص تنتمي إلى التقليد المذكور يوحي بإحتمال إستخدام الإرجاع غير المباشر في النماذج الثنائية أو مجرد الإنزلاق من الفحوى إلى المرجع إليه في تحديد معنى الإشارة من المؤكد أننا ما إن نتبنى أفهومي الأيقونة والتأشيرية البيرسيين نحتاج أن نذكر أنفسنا أننا لم نعد نضع المرجع إلية جانبا وأننا لا نعترف فقط بوجود إطار نسقي للإرجاع ,لكن أيضا بنوع من السياق الإرجاعي يتخطى منظومة الإشارة في حد ذاتها تستند الأيقونة إلى التشابة أو على الأقل ما ندركة من رابط مباشر , بعبارة أخرى إن تبني مثل هذه الأفاهيم يعني أننا تخطينا الحدود الرسمية للإطار السوسوري الأصلي (كما في البنيوية بحسب جاكابسون ) حتى وإن لم نتبن كل المعالجة البيرسية .
وبالنسبة إلى العلاقة بين الدال والمدلول ,الصيغة الثانية أقل إصطلاحية من الأولى ,والثالثة أقل من الثانية ,والإشارات الرمزية اللغة هي على الأقل إصطلاحية جدا ,وتدخل في الإشارات الأيقونية دائما درجة معينة من الإصطلاحية أما الإشارات التأشيرية متوجة الإنتباه لزاما إلى الموجودات التي تدل عليها ,ويمكن إعتبار الدالات التأشيرية والأيقونية مقيدة أكثر بالمدلولات المرجعية بينما يمكن إعتبار دالات الإشارات الرمزية (الإصطلاحية بدرجة أكبر ) ومحددة أكثر لمدلولاتها وتختلف درجة إصطلاحية الإشارات ضمن كل صيغة ويمكن تطبيق مقاييس أخرى للتمييز بين الصيغ الثلاث بطريقة أخرى وعلى سبيل المثال يرى هودج وكريس أن التأشيرية تستند إلى فعل حكم أو إستنتاج بينما تقترب الأيقونية من الإدراك المباشر وهما يعتبران أن الشارة الأيقونية تملك الحد الأعلى من الموقفية ويستعمل أحيانا المصطلحان ,تحفيز وتقييد , لسوسور لوصف مدى تحديد المدلول للدال كلما قيد المدلول الدال إزداد تحفيز الإشارة ,الإشارات الأيقونية محفزة جدا أما الإشارات الرمزية فغير محفزة وكلما كانت الإشارة أقل تحفيزا أزدادت الحاجة إلى تعلم إصطلاح متفق علية ,ويؤكد معظم السيميائيين على دور الإصطلاح بالنسبة إلى الإشارات وكما سنرى حتى الصور الشمسية والأفلام تنبني على أصطلاحات يجب أن نتعلم قرائتها وهذة الإصطلاحات جزء مهم من البعد الاجتماعي للسيميائية .
وهنا نستطيع القول أن علاقة النسبية بالسيميائية هي علاقة بناء توافقي للنتائج التي يتوصل إليها الباحث اللغوي أو الكاتب أو الباحث الاجتماعي وكل ما سبق هو نسبي أو يخضع للنسبية من أجل تحصيل نتائج تشعرة بالرضى عما يقوم لأجل عملة في خدمة البناء الاجتماعي ,ويمكننا القول أنا كل ما يقوم به الإنسان من أفعال بحثية أيما كانت نتائجها فهي تقدم قيمة مظافة للمجتمع حتى وإن كانت لا ترقى لما يطمح إلية .
أتمنى لكم تحقيق ما تتمنون جميعا , وكما قلت سابقا كل ما نقوم به هو خلق حالة تفاعلية غايتها زيادة الوعي بتعلم المزيد من هذه الأبحاث التي قد تجعل واقعنا المجتمعي أفضل وأرقى . ولكل من فاتته بعض المعاني أو واجة صعوبة في تحليل بعض رموز الكلام أترك لنا في التعليقات ما تحتاج إيضاحة ونحن سنقوم بتفسيرة بالمطلق لتعم الفائدة .
دمتم بخير ولكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق .
أسامة حريدين

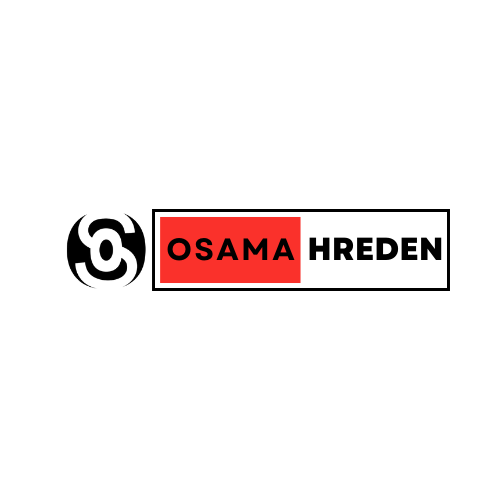
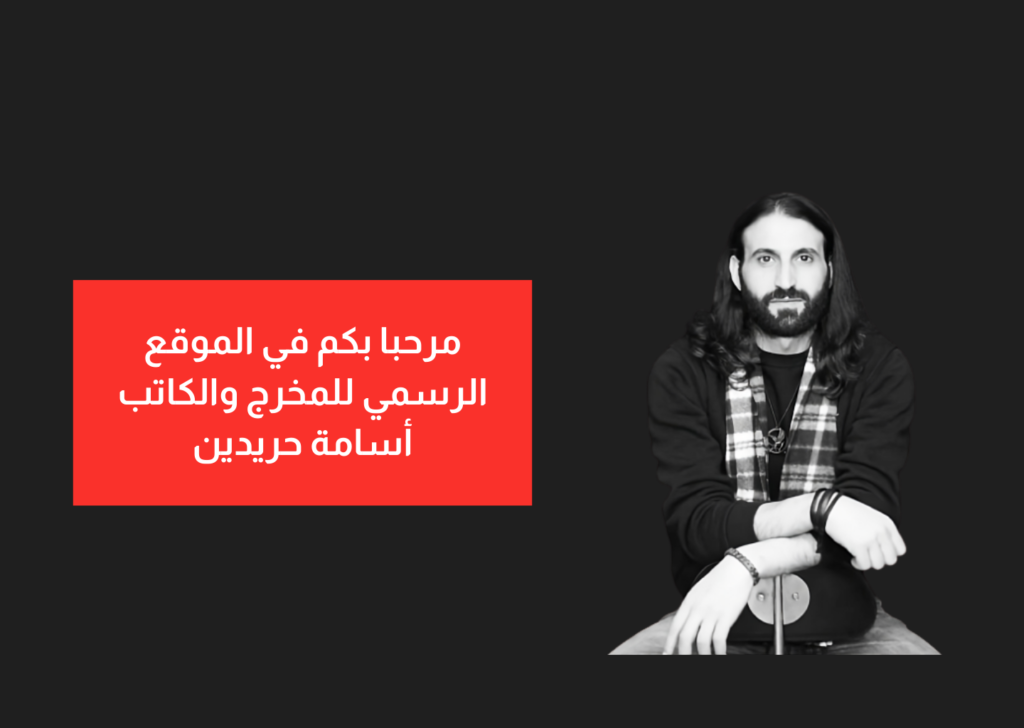
I appreciate the humor in your analysis! For those interested, here’s more: FIND OUT MORE. What do you think?
What a great read! The humor was a nice touch. For further details, click here: READ MORE. Let’s chat about it!
This piece was both insightful and engaging. Id love to dive deeper into this topic with you all. Check out my profile for more content!